السؤال:
لما أشعر أن التفاؤل التام بالله عبارة عن وهم؟ قرأت مرة عبارة تحث على التفاؤل وتوقع المراد بحجة أن كل متوقع آت. لكني لا أشعر أن ذلك صحيح! و يتعبني جدًا توقع الثراء و الصحة و النجاح لأني قد فعلت ذلك مسبقًا و انتهى الأمر بشكل مؤلم، لماذا يؤلمني توقع الخير من الله تعالى؟ هل لأن تجاربي السابقة لم تنته بالشكل المطلوب؟ وأن دعائي لم يُستجب؟
أنا أحب الله و أحب الدعاء و أشعر بالذبول عندما ابتعد عنه وأخاف أن لا أؤمن بكل أركان الإيمان مثل آخر ركن وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، هل لذلك شأن في كراهيتي للتفاؤل؟ هل تفكيري الواقعي هو نتيجة نقص في الايمان؟ وهل حقًا كل متوقع آت؟ لأنني لا أظن أني توقعت الفقر أو عدم نجاح إخوتي و لم أتوقع أني سأكون عاطلة عن العمل بعد تخرجي و لم أتوقع أن عائلتي سيستمر في استئجار البيوت دون اتخاذ قرار لشراء منزل، وهناك عدة أمور لم تحدث مثلما توقعت، على ماذا يدل هذا؟ و هل أنا سيئة لأني أنفر من التفاؤل رغم معرفتي أن الله على كل شيء قدير؟
الجواب:
شكرا لسؤالك الواضح الذي يستدعي إجابة واضحة تجلي الفروق بين “التفاؤل” و“الواقع” و“الإيمان”.
أولًا: لماذا يؤلمك التفاؤل؟
يؤلمك التفاؤل لأنك ربطته بالنتائج الدنيوية. عندما كنت تتفائلين بالنجاح أو الثراء أو الصحة، كان التفاؤل في ذهنك يعني “أن الله سيحقق ما أريده كما أريده”.
لكن حين لم يحدث ذلك، شعرتِ أن التفاؤل مجرد وهم، لأنك كنتِ تتوقعين أن التفاؤل = ضمان النتائج.
بينما الحقيقة الإيمانية تقول: التفاؤل الحقيقي هو “اليقين أن ما سيحدث لي، وإن خالف أملي، فهو خيرٌ لي”. بنا على القاعدة القرآنية:
﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]
فالإيمان لا يُختبر في لحظة الاستجابة، بل في لحظة الخيبة.
فحين يقول الله تعالى: “وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم”، فهو يُعلّمنا أن التفاؤل بالله يعني الثقة في حكمته لا في مشيئتنا. روي أن رسولنا الكريم قال:
“جَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له”. (صحيح مسلم)
ثانيًا: هل ضعف الإيمان بالقدر هو السبب؟
ليس بالضرورة “ضعفًا”، بل هو اضطراب إنساني طبيعي بين القلب والعقل.
العقل يرى الوقائع المؤلمة فيقول: “إذن الدعاء لا يُغيّر شيئًا”. لكن القلب المؤمن يقول: “الله لا يردّ الدعاء، إنما يدّخره أو يصرف به شرًا”. يقول الله تعالى:
﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62]
وهذا الصراع لا يعني أنك لا تؤمنين بالقدر، بل لا تؤمنين بما يفسره عامة المسلمين عنه، وتفسيرهم للقدر خاطئ، ولهذا أنت محقة في تساؤلك عنه. وهذه المجاهدة نفسها من أعظم صور الإيمان.
*ولمعرفة المعنى الحقيقي للقدر يرجى الاطلاع على المقالة التالية: هل يعدُّ الإيمان بالقدر من أركان الإيمان؟
ثالثًا: هل الواقعية نقص في الإيمان؟
الواقعية ليست نقصًا في الإيمان، بل هي بصيرة تقود إليه وتعمقه، لأنه يكون حينها مبني على أساس متين وأدلة قوية، فأن تكوني واقعية يعني أنك تفهمين أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار مثالية. لكن الخطأ هو أن تتحوّل الواقعية إلى تشاؤم يطفئ الرجاء بالله تعالى، فالإيمان الحق يجمع بين: العقل الواقعي الذي يدرك سنن الله في الحياة، والقلب المؤمن الذي يرجو رحمة الله فوق كل سبب.
رابعًا: “كل متوقع آت” هل هذا صحيح؟
هذه العبارة ليست مطلقة. فكم من أناس توقعوا النجاح وفشلوا، وتوقعوا الفشل فنجحوا!. فهذه العبارة تُناسب التحفيز البشري، لكنها ليست مبدأ إيمانيًا. أما في الإيمان فالصحيح أن يجعل المؤمن ظنّه حسنًا بالله تعالى، لا لأنك تملك النتيجة، بل لأنك تثق أن الله سيجعل لك في النهاية خيرًا مهما كان شكله. قال الله تعالى:
﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: 128] [القصص: 83]
خامسًا: لستِ سيئة لأنك تنفرين من التفاؤل.
فما تشعرين به هو خوف من تكرار الألم، لا نفور من الله تعالى. فأنتِ تحبين الله، بدليل أنك لا تطيقين البعد عنه. لكنك تتألمين لأنك لا تعرفين لماذا لم يُستجب لك كما تمنيتِ. وهذا بحد ذاته حوار صادق مع الله، والله يحب العبد الذي يسأله بصدقٍ وحرقة.
قال الله تعالى:
﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]
﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60]
وختاما:
الأصل أن يتفاءل المسلم بالله لا بالظروف. وبهذه النية سيزول الألم شيئًا فشيئًا، لأن التفاؤل لن يكون حينها مطالبة بنتائج، بل ثقة في الخالق العظيم وطمأنينة في كل حال.
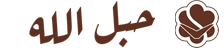


هناك سؤال آخر بخصوص كُتّاب الوحي وجمع القرآن، وكذلك إضافة النِّقَاط إلى الأحرف، لأن حروف القرآن في البداية كانت بلا نِقَاط كما اعتاد العرب.
أشعر أن هذا الادعاء غير صحيح، وقد بحثت في موقعكم ولم أجد مقالًا يتناول هذا الموضوع. هناك من يقول إن القرآن نزل على النبي ﷺ مكتوبًا، وليس كما يُزعم أنه جُمِع في وقت لاحق، وأن النِّقَاط أُضيفت إلى الحروف بعد ذلك.
بل أرى أنه نزل بالنِّقَاط، إذ كيف يجعل الله كتابه في أيدي البشر ليضيفوا إليه أو ليختلط عليهم الأمر في حرف قد يُغيِّر المعنى؟
وهذا يجعلني أستنتج أنه لا وجود لما يُسمَّون «كُتّاب الوحي» الذين كان النبي ﷺ يُملي عليهم فيكتبون، أو أن معنى «أمّي» لا يدل على أنه لا يعرف القراءة والكتابة، بل على أن قومه لم يُنزَّل عليهم كتاب سماوي من قبل، ولم يُرسل إليهم أنبياء سابقون.
فلو افترضنا أن القرآن نزل على النبي شفهيًا، ثم كتبه كُتّاب الوحي بدون نِقَاط على الأحرف، وأُضيفت النِّقَاط بعد ذلك، فهل من المنطقي ألا يراجع النبي ﷺ هذه النِّقَاط بنفسه للتأكد من مطابقتها للوحي؟
خاصة أن الله في كثير من الآيات يشير إلى أن الذي نُزِّل على النبي وحيٌ مكتوب، مثل قوله تعالى: «ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ»، و**«سُبْحَانَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ»**، وغيرها من الآيات التي تُركِّز على لفظ الكتاب، أي أنه نزل مكتوبًا.
أما القول بأن النِّقَاط أُضيفت إلى الأحرف بعد وفاة النبي ﷺ بسنوات، فهذا يثير التساؤل: كيف تم اعتمادها وهو غير موجود لمراجعتها؟ فنحن حتى في الأمور الدنيوية عندما يُعِدّ أحد طلاب العلم رسالة ماجستير أو دكتوراه، لا بد من مراجعتها من قبل المشرف، فكيف برسالة ربانية ستُتلى إلى قيام الساعة؟!
فأين النبي ﷺ من مراجعة هذه النِّقَاط واعتمادها؟
ثم إن الصحابة لم يكونوا معصومين، وربما وقع أحدهم في خطأ، فإذا قلنا إن الصحابة والتابعين هم من كتبوا القرآن وأضافوا النِّقَاط إلى حروفه، فسنقع في فخ الذين يؤمنون بما يسمونه «الوحي الثاني»، أي الأحاديث، وزعمهم أن مَن نقل الأحاديث هم أنفسهم مَن نقلوا القرآن، وأن رفض بعض الأحاديث الصحيحة السند يؤدي لاحقًا إلى رفض القرآن نفسه، وهكذا يُخَوِّفون أتباعهم من نقد الأحاديث.
هل يمكن توضيح هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا مقدمًا.
جزاكم الله خيرا
كنتُ قد قرأت في موقعكم هنا سؤالًا حول معنى كلمة «الناس» في القرآن الكريم، لأن بعض المفكرين يقولون إنها تعني الرجال فقط.
وقد كانت إجابتكم تنفي هذا المعنى، وأنا مقتنعة بذلك، لكن استوقفتني بدايات سورة النساء:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ}
ثم يأتي بعد ذلك الكلام موجَّهًا إلى فئةٍ معينة من الناس، حتى نصل إلى قوله تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا…}
وهذا الخطاب موجَّه بالتأكيد إلى الرجال!
لكن أوّل الخطاب كان بـ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، فكيف تكون كلمة «الناس» هنا شاملة للرجال والنساء، بينما سياق الآيات بعد ذلك يتحدث عن أحكام تخص الرجال فقط؟
وإن افترضنا أن «الناس» هنا تعني الرجال، فكيف نُفرِّق بين المواضع الأخرى في القرآن التي وردت فيها الكلمة، وهي كثيرة جدًا؟
لأن من يتبنّى هذه الفكرة يقول إن النساء غير مكلَّفات، وإن خطاب الله موجَّه للرجال فقط، حتى في الأمور الخاصة بالنساء، لأن الرجل هو المكلَّف عنها.
واستدلّوا أيضًا بأن الله قال في سورة الأعراف:
{وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ…}
[الأعراف: 46]
وقالوا إن وجود «الرجال» فقط في هذا الموضع دليل على أن الخطاب الإلهي خاصٌّ بالذكور.
فأرجو منكم التوضيح، لأن هذا الموضوع حيّرني كثيرًا.
وشكرًا مقدمًا.
شكرا لهذا السؤال القيم
سؤالك يتعلق ببابين مهمين من علوم القرآن:
الأول: الخطاب القرآني العام والخاصّ.
الثاني: دلالة الألفاظ المشتركة (كلمة “الناس” مثلًا).
معنى كلمة «الناس» في القرآن
كلمة «الناس» في اللغة العربية تشمل جميع بني آدم — رجالًا ونساءً — ولا تُطلَق على الذكور فقط، إلا إذا دلّ السياق على التخصيص.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة:
“النون والواو والسين أصلٌ يدلّ على ظهورٍ وبروزٍ، ومنه الناس، لأنهم ظاهرون في الأرض.”
أي أن الكلمة لا تفرّق بين الذكر والأنثى.
وقال الطبري في تفسير قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ}: أي يا جميع بني آدم، المؤمن والكافر، الذكر والأنثى.
فالأصل في لفظ «الناس» أنه لفظ عام يشمل الجميع، ولا يُقيَّد بجنس أو فئة إلا إذا خصّصه السياق.
لماذا بدأ الله سورة النساء بـ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} ثم تحدّث عن أحكام تخص الرجال؟
هذا من أسلوب القرآن البليغ. فالله تعالى بدأ الخطاب بـ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} لتذكير الجميع – رجالًا ونساءً – بأصل الخَلْق ووحدة البشرية، فقال:
{خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا…}
ثم بعد هذا التمهيد العام، انتقل الخطاب إلى بيان أحكام معيّنة تخصّ فئة من الناس، وهم الرجال، كأحكام الزواج واليتامى والمهور.
فالخطاب العام يشمل الجميع، لكن التفاصيل التالية تُوجَّه إلى من يختصّ بهم الحكم.
وهذا لا يعني أن “الناس” = الرجال، بل أن الخطاب تغيّر سياقه من العام إلى الخاص.
مثال توضيحي:
المثال: قوله تعالى في سورة آل عمران (173–174)
﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾
﴿فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾
التحليل اللغوي والبياني:
الكلمة «النَّاس» تكررت مرتين في الآية نفسها، ولكن بمعنيين مختلفين:
1. الموضع الأول:
﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾
المقصود بـ «الناس» هنا شخص معيّن أو جماعة محددة من الناس، وليس عموم البشر.
والمفسرون (كالطبري والقرطبي وابن كثير) يذكرون أن القائل هم مجموعة من المنافقين الذين أرادوا تخويف المؤمنين بعد معركة أحد.
إذًا: الناس هنا لفظ خاص، وإن كان لفظه عامًا.
2. الموضع الثاني:
﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾
المقصود بـ «الناس» في هذا الموضع هو عموم المشركين من قريش وحلفائهم الذين تجهزوا لقتال المؤمنين.
وهنا صار المعنى عامًّا يشمل فئة كبيرة من البشر (العدوّ كلّه).
إذن في السياق نفسه:
• «الناس» الأولى خاصة (شخص أو فئة محددة من المنافقين أو المخذّلين).
• «الناس» الثانية عامة (الكفار أو عموم العدوّ).
هل النساء مكلَّفات بالشرع مثل الرجال؟
نعم، النساء مكلَّفات تمامًا كالرجل، وهذا ثابت بنص القرآن الكريم. قال تعالى:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97]
{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ… أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]
فهاتان الآيتان وحدهما تُبطلان تمامًا القول بأن النساء غير مكلَّفات.
بل إن الخطاب القرآني حين يأتي بصيغة المذكر، يكون على طريقة العرب في شمول اللفظ المذكر للذكور والإناث معًا، إلا إن دلّ الدليل على التخصيص.
قولهم إن “الرجال فقط على الأعراف”
الآية التي استدلّوا بها لا تدلّ على أن النساء غير موجودات أو غير مكلَّفات، بل تتحدث عن فئة من الناس (رجال) كان لهم دورٌ معيّن.
قال المفسرون:
«وعلى الأعراف رجال»: أي جماعة من المؤمنين، سُمّوا رجالًا تغليبًا للمذكر، وقد تكون فيهم نساء، كما هو أسلوب القرآن والعربية.
والتعبير بالمذكّر في مثل هذه المواضع لا يعني حصر الخطاب على الذكور، بل هو أسلوب لغوي شائع يشمل الجميع.
قال تعالى في موضع آخر:
{رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}
والمقصود بهم المؤمنون الصادقون جميعًا، وليس الرجال فقط.
﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 36- 37]
فكلمة “رجال” هنا لا يقتصر معناها على الذكور، بل تشمل النساء اللاتي هذا وصفهن، لكنه ذكر الرجال تغليبا، لأنهم يرتادون المساجد أكثر من النساء.
قاعدة مهمة في فهم الخطاب القرآني:
اللغة العربية تقوم على قاعدة أن: “المذكّر إذا أُطلق شمل المذكر والمؤنث ما لم يأتِ دليل على التخصيص.”
ولهذا فخطاب القرآن الموجَّه بـ “يا أيها الناس”، أو “يا أيها الذين آمنوا”، يشمل الرجال والنساء معًا، لأن كلاهما داخل في وصف الإيمان أو الإنسانية.
أما تخصيص بعض الأوامر بالذكور، مثل “فانكحوا”، فهو لأن الزواج في تلك الصيغة خاصّ بدور الرجل في العقد باعتباره الطرف المباشر له والمكلف بتبعاته كدفع المهر والنفقة وغيرهما، بينما جاءت أحكام أخرى تخص النساء في مواضع أخرى بخطاب خاص للمؤنث لأنه لا يشمل الذكور، مثل قوله تعالى:
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: 228]
فكلٌّ له نصيبه من الخطاب الشرعي.
الخلاصة
-كلمة «الناس» في القرآن تشمل جميع البشر، رجالًا ونساءً.
-بدايات سورة النساء خطابٌ عام للتذكير بالأصل الإنساني الواحد.
-بعدها انتقل القرآن إلى أحكامٍ تخصّ الرجال لأنهم المعنيون بتلك المسائل في السياق.
-النساء مكلَّفات شرعًا مثل الرجال تمامًا، والقرآن صرّح بذلك.
-لفظ «رجال» في القرآن لا يعني نفي وجود النساء، بل هو تعبير لغوي تغليبي.
-القول بأن النساء غير مكلَّفات باطل تمامًا ولا يقول به أحد من علماء الإسلام المعتبرين.
-الخطاب للمذكر يشمل الجنسين بينما الخطاب للمؤنث يقتصر على جنسهن.
شرحكم ممتاز حقا واستفدت منه كثيرا الله ينفع بكم ويوفقكم
وعندي رأي يحتمل الخطأ او الصواب بخصوص «وعلى الأعراف رجال» الا يمكن أن تحتمل نفس معني {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} قالوا معنى رجالا لا تعني الذكور دون الإناث بل تعني انهم يأتون سيرا بارجلهم
فلما لا يكون نفس المعنى ؟
هذا مثال صحيح على ما ذكرنا
شكرا جزيلا لك