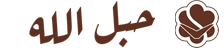الباحث الإسلامي
عمرو الشاعر
بعد رحلة فكرية طويلة :
– اكتشفتُ أن القرآنَ جاءَ للإنسان، أن القرآنَ أرادَ الإنسانَ، أنَّ الإنسانَ قبلةُ القرآن،
بينما جعل العلماء/ الفقهاء/ المشايخُ الإنسانَ للدين، وجَعَلوا أعظمَ وأرفعَ دورٍ له هو “طلب العلم” (أي ما يسمونه بـ “العلوم الشرعية” !)، فإن لم يستطع طلبها، لأي سبب من الأسباب، وَجَبَ عليه التقليدُ فيها !
في حين دوري الرئيسي والأعظم والأرفع هو أن أحيا إنساناً بالأخلاق، أتقرب إلى الله بذلك [..].
– اكتشفتُ أن القرآنَ جاء تحريراً للناس من الأوهام والأباطيل، والآصار والأغلال التي كانت عليهم، ولهذا جاء بأقل ما يمكن من الإلزامات والواجبات الدينية، في إطارٍ تزكوي قويم،
إلا أنَّ العلماء/ الفقهاء/ المشايخ راكموا قوائم لا تُحْصَى من الواجبات والمحرمات والمطلوبات الدينية فوق ظهور المسلمين حتى أَنَّتْ وأَطَّتْ مِن حَمْلِها ! [..]
2- إن الدين إنما جاء لـ “تقويم” الإنسان لا لـ “إنشاء” الإنسان (كما يصور لنا المشايخ !) [..]، وجاء لـ “يُشْعِرَه بذاته” لا لـ “يطمسها” [..]؛ إذ للإنسان أَنْزَلَ اللهُ الدين، هدايةً وتزكيةً ورشاداً ونوراً [..]، إلا أنَّ مَن نَصَّبُوا أنفُسَهم “قائمين على الدين” أسسوا، بمرور الزمن، “منظوماتٍ كلاميةً وأصوليةً وفقهيةً وسلوكيةً” ضخمة (أصبحت من المُسَلَّمات عند عامة المسلمين وخاصتهم !)، رأوا أنَّ بها سيكون “التطبيقُ الأمثل للدين”، وأنها ستكون “المرجع الذي يُتحاكم إليه وبه يُرْفَعُ الخلافُ” !
إلا أن هذه المنظومات :
– لم تُفْلِح في إخراج “جيل إنساني متدين”، وإنما كانت سبباً في التعسير والتضييق على المسلمين، وفي التنفير من الدين ! [..] ومعها، لم يَعُد الدين دفعاً وتخفيفاً، وإنما صار إصراً وعبئاً !
– كما إنه لم يُحْكَم تأسيسُها في ضوء القرآن الكريم،
– فضلاً عن تعاملها – في واقع أمرها- مع الدين باعتباره “مجموعة نصوص متناثرة متقطعة”،
– فضلاً عن اعتماد أكثرها على “الظنيات” (مثل المرويات الآحادية) التي هي – بطبيعتها- ساحةٌ شاسعةٌ لتفاوت واختلاف العقول فيها إثباتاً وإدراكاً وغوصاً .. إلخ، مما جعل من هذه المنظومات ساحاتٍ لا تنقطع من الاختلافات والجدالات والمجادلات والتراشقات “المقدسة” ! [..]
لقد أصبحت هاتيك المنظومات والتأصيلات “ديناً”، فتضخم الدين وتشعب وتعقد، وصار حِمْلاً بعد أن كان دَفْعاً، ولم يَعُد الدين لكل الناس، وإنما لكبار العلماء والفقهاء ! [..]
ورغم أن جُل المشايخ يُنادون، بلسانهم، بالتجديد، إلا أنهم يهاجمون المجددين؛ لأنهم يريدون تجديداً في حدود القديم ! [..]
3- إن النعت بـ “الإنسانية”، عند كثير من المتدينين في بلادنا، إنما هو رميٌ بالضلال، لأنه اتباعٌ لمذهبٍ ضالٍّ مُعادٍ للدين ! [..]
لقد رُبِّيَ هؤلاء المتدينون على ألا يسمعوا لاحتياجات كياناتهم البشرية، وإنما أن ننتظرَ ماذا قال أو سيقول مشايخنا، ففي قولهم الحق الصُّراح، فهم يُقَدِّمون لنا “الإسلام”، ولا حاجة لنا بشيء آخَر مع هذا الذين يقدمونه ! [..]
بينما المسلمون الأوائل كانوا يستجيبون لدواعي إنسانيتهم دون انتظار نص، وهي التي هَدَتْهُم إلى أن يُطْعِموا الأسيرَ (الذي ليس على دينهم)، فنزل القرآنُ- على سبيل المثال- مادحاً فِعْلَهم مُثْنِياً عليهم : “ويُطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً” [الإنسان 8]، فقد أدركوا أن الدين إنما جاء ليُرَقِّي البَهِيمي عن بَهِيميته فيجعله إنساناً، فالدينُ إحياءٌ وتقويةٌ وإعلاءٌ للإنسانية.
إلا أن التربية المنظومية المشيخية الفقهية : هَمَّشَت الإنسانية/ البُعد الإنساني، فأصبح أكثرنا بحاجة إلى مَن يُذَكره بالبُعد الإنساني الذي طُمِسَ فيه ! [..]
وليت الأمرَ قد وَقَفَ عند هذا فقط، وإنما تَعَدَّى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث :
– جُرِّدَ من ثوبه الإنساني، وصُيِّرَ “هيكلاً جسدياً” يُلْقَى الكلامُ على لسانه وحياً في جُل المواقف !
– كما جُرِّدَت أقوالُهُ عن مناسباتها/ ملابساتها، وعُمِّمَت لتصبحَ أحكاماً مطلقةً !
– فظهرت إشكاليات جَمَّة، وُضِعَت لها قواعد وأصول لتجاوزها أو تخفيف عُسرها، فما زادت الأمرَ إلا تعقيداً !
– فأدت هذه المحاولات “الترقيعية” (المليئة بالمتناقضات) إلى تشويه الدين ذاته وتمييع معالمه !
– وكان “المشترك الأعظم” بين هذه التصورات والمنظومات والتأصيلات كلها : كون الدين بحراً مترامي الأطراف، متلاطم الأمواج، ومن ثم، من غير الممكن لغير المتفرغ الإحاطةُ به، ومن ثم وجب أن يكون هناك “خاصة” و”عامة”، وأن تُذْعِنَ الثانيةُ للأُولَى ! [..]
كما جَرَّدوا، فعلياً، [حركةَ الإنسان في الحياة من أصل الإباحة/ الفسحة/ السعة أو العفو أو السكوت التشريعي، المتروك تنظيمه، مسموحاً وممنوعاً، للإنسان، في ضوء “القيم”]، فزعموا أن لكل فعلٍ كبيرٍ وصغيرٍ “حُكماً شرعياً”، وأن علينا أن نبحثَ عن مُسْتَنَدٍ له في التأصيل “الديني” لحليته أو وجوبه أو حرمته ! [..]
كما ارتقوا مرتقىً صعباً وعراً، حيث جعلوا من اجتهاداتهم وآرائهم “حُكْمَ الشرع”، وهذا تقولٌ على الدين ! بينما لم يكن المسلمون الأوائل يقولون : “هذا حلال، وهذا حرامٌ، إلا لِمَا كان فيه نصٌّ صريحٌ”، وكانوا يقولون فيما يُسألون عنه : “أكره هذا، لا أحب هذا، لا ينبغي هذا، لا بأس بهذا”، ولم يكن هذا محضَ تَوَرُّعٍ كما يزعم البعض، وإنما هو المسلك السليم القويم؛ تجنباً للافتراء على الله ودينه.
لقد خاض القرآن المجيد معركة حامية الوطيس ضد “الطاغوت”، طبقة الكُهان الذين يختلقون أمراً وينسبونه لله تعالى، ففعلهم هذا نوعٌ من “الطغيان”؛ لأنهم تَعَدَّوْا حدودهم ونَصَبُوا أنفُسَهم آلهةً للبشر، تتحدث باسم الله، وتحدد ما هو حلالٌ عند الله وما هو حرامٌ ! ولكنْ، لِضياعِ الوعي بهذا ظهرت طبقة الفقهاء التي تَنْسِبُ حُكماً إلى الله في مسألةٍ غيرِ موجودةٍ صراحةً في كتاب الله، وهي تظن أنها تحسن عملاً !
مما ساهم في طمس دور “التربية القرآنية” التي تهدف إلى “تنمية عقل وضمير” كل إنسان مسلم، مما يُمْكِنه به أن يُحَكِّمَ عقله وضميره فيما يطرأ عليه من أمور، [ليقررَ أي المسالك فيها أفضل وأزكى وأرقى وأصلح]، وأنه على مخالفة ذلك (أي مخالفة ما يتضح للإنسان بعد تحكيمه لعقله وضميره) سيُحاسَب، واللهُ تعالى لم يُنزل الوحيَ ليجعلَ المؤمنين به [“زَكَائِبَ معلوماتٍ” أو “مُتَلَقِّين سلبيين”]، وإنما “ناظرين مفكرين”، فإذا لم يستطع المرءُ أن يصلَ إلى قرارٍ يطمئن إليه في هذا الأمر أو ذاك، لأي سبب من الأسباب، واستعانَ بمَن يتوسم فيه المَعُونة والعونَ والرشادَ، فليكن رَدُّ هذا الأخير كرد المسلمين الأوائل : أحب هذا، ينبغي هذا، أكره هذا، هذا خِلافُ الأَوْلَى .. إلخ.
هذا ما كان عليه المسلمون الأوائل، حيث :
– لم يكونوا يعتمدون، ولا يعرفون، [التقنينات أو المناهج أو القواعد أو المفاهيم أو التصورات الصناعية] التي نشأت لاحقاً؛ فهم لم يكونوا يتقيدون بمثل هذه الأمور،
– وإنما كان مُنْطَلَقهم “المصالح الكلية”، وإن شئتَ الدقةَ قلتَ : كان مُنْطَلَقهم “استحضارَ اللهِ في المسألة”، ما أَوْلَى المواقف هنا بالحق، [أو أقربها إلى ذلك]، أو أحبها إلى الله، [أو أقربها إلى ذلك] ؟ وهل في هذا الفعل عدلٌ أم ظلمٌ ؟ تَزَكٍّ أم تَدَسٍّ ؟ توازنٌ أم إسراف ؟ صلاحٌ أم فسادٌ ؟ .. إلخ،
فـ :
– إذا كان فيه أحد الوجوه الأُولَى المذكورة، [أو ما هو أقرب إليها]، أَحَبُّوه وحَبَّذُوه وفَضَّلُوه ونصحوا به.
– وإذا كان فيه أحد الوجوه الثانية، [أو ما هو أقرب إليها]، كَرِهوه وتركوه ونصحوا بالابتعاد عنه،
دون أن يُحْشَر في هذا المقام أو ذاك “حُكمٌ إلهي” مزعومٌ : بالحل أو بالحرمة، بالإيجاب أو بالمنع !
مما يعودُ بالأمرِ إلى ضميرِ مَن استعانَ بهؤلاء، حيث يُفْتَرَض فيه أن يَزِنَ ما يُقال له، لا أن يقبله أو يَرُدَّه دون بصيرة !
ولهذا فنحن ننظر إلى “الإنتاج الفقهي الإسلامي التراثي” باعتباره أقرب ما يكون إلى “الإرشادات التهذيبية” أو “القوانين المدنية”، لا أنه – بذاته- دينٌ يُتَعَبَّدُ لله به،
وإنما يُتَقَرَّبُ لله، ويُتَعَبَّدُ اللهُ، باقتناعِ الإنسانِ بصلاحِ أو فسادِ أمرٍ أو تصرفٍ تبعاً لقناعاته القائمة على ركائز قرآنية عقليةٍ ضميريةٍ معاً، فيفعلَ هذا أو يجتنبَ ذاك ابتغاءَ مرضاةِ الله تعالى، وَفْقَ ما اقتنع به،
فبما وَقَرَ في عقل وقلب وصدر الإنسان : يتعبدُ المرءُ لربه [..].
وهذا المنظور سيُغَيِّرُ جُل المنظومة [التراثية] المستقرة المُتعارَف عليها بين المسلمين، والناسُ غالباً ما يستنكرون الجديدَ، ونحن لا نبالي بهذا !
من كتاب: فقه الإنسان للأستاذ عمرو الشاعر