الموازنة بين الروح والجسد
أ د. عبد العزيز بايندر
الإنسان هو كائن مركب من البدن والروح. وبالروح يفترق الإنسان عن الحيوانات الأخرى. ولكن بسبب إنكار رجال العلم كون الروح كائنا مستقلا، قد انحصر الموضوع إلى مجال الدين. فأدّى هذا إلى فقدان التوازن بين الروح والجسد. وبالتالي إلى مفاهيم خاطئة في الروح وعلاقتها بالجسد.
والقرآن الكريم يعطينا معلومات هامة عن الإنسان. وحين ندرس الآيات التي تتحدث عن الإنسان نرى أن الروح تُنفخ فيه حين يستوي الجنين، ويكون هذا في الأسبوع الخامس عشر. ويبقى الجنين في بطن أمّه بعد أن يُنفخ فيه الروح ستة أشهر. ويبدأ الجنين يأخذ شكلا مختلفا عن بقية الحيوانات حين ينفخ فيه الروح. قال الله تعالى: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ؛ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ؛ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ» (السجدة، 32 / 7-9).
الجسد للروح بمثابة البيت لها. تخرج في المنام، وتعود إليه حين يستيقظ. فحين يموت الإنسان يصير الجسد كالبيت المهدَّم. ولا يمكن للروح أن تعود إليه حتى يُخلق من جديد. كما قال الله تعالى:
«اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الزمر، 39 / 42.
والنوم ضروري للراحة، كما أنّ الموت ضروريٌّ لأن يكون الجسد مناسبا للحياة الأبدية التي لا يعتريه فيها مرض ولا فساد وهرم. وحين تعود الروح في الجسد يوم القيامة يقوم الإنسان كقيامه من النوم. كما أخبرنا الله تعالى عن هذا بقوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ؛ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» (يس، 36 / 51-52).
علاقة الروح بالجسد
يعرف الإنسان عموما بأنه حيوان ناطق أو أنه حيوان مفكر. وعلى هذا يُعدُّ العقل الفرق الهام الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان. ونفهم من القرآن الكريم أنّ الفرق يبدأ بنفخ الروح؛ حيث يجعل الله تعالى له الفؤاد والسمع والبصر. أمّا النطق فليس وصفا خاصا بالإنسان، حيث إنّ الطير والنّمل وحتى الجمادات تنطق وتنظر إلى الأحداث مثل العقلاء.[1]
وبنفخ الروح تكسب العين قوة البصر والأذن قوة السمع ويصير القلب مركز صدور الحكم. أما العقل فهو كمستشار للقلب. ولذا كان الإيمان في العقيدة الإسلامية تصديقا بالقلب.
من الممكن أن العين ترى الحق والأذن تسمعه ولكن ربما يرفضه القلب، فيحدث بذلك قلق نفسي عند هذا الشخص؛ للتعارض بين ما يحسه بجوارحه وما أصدره قلبه من قرار برفضه. فيبدأ الإحتكاك والصراع بين القلب والعقل، فيفقد هذا الشخص التوازن وراحة البال، فبمرور الزمن تصبح العين لا ترى والأذن لا تسمع إلا ما يريده القلب. وفي هذه الحالة لا يبقى أمام القلب إلا أن يلغي فعالية العقل، ويذهب إلى الكذب ليبرر نفسه، ويشكل بيئة كاذبة ليعيش فيها مع من يشاركه الحال من المجرمين، أو يشارك المجرمين ويعيش في بيئتهم الكاذبة، وفي بيئة كهذه لا يمكن للمخلصين أن يكون لهم مكان.
والإحتكاك بين القلب والعقل، يحمل البعض على شرب الخمر وتناول المخدرات والسلوك الجنونية التي تؤدي إلى كراهية النفس. وبالرغم من ذلك كله فربما عرضوا أنفسهم كمصلحين وهم الذين أفسدوا التوازن، فلا ينتظر منهم الإصلاح، لأن من أفسد نفسه فلا يمكن له أن يصلح غيره.
هذا التوازن الذي يفرق الإنسان من غيره من الحيوانات. أي أن المركز الأساسي الذي يتحكم في الإنسان هو القلب وليس العقل، والقلب هو الروح، أمّا العين والأذن اللتان يتحكم القلب فيهما هما عين القلب وأذنه.
أبو البشر
يزعم التطوريون أن الإنسان قد تطور من القردة نظرا إلى التشابه بينهما. والإنسان يفترق عن الحيوان بالروح، فلا يصحُّ أن نقول أنّ حيوانا من أي نوع يمكن أن يكون أبا له.
ولو شبهنا الإنسان بالحاسوب الآلي، فيكون الجسد كجهاز الحاسوب، والحياة كالكهرباء، والروح كالبرامج المثبة فيه. ومن المعلوم أن الحاسوب يفترق بتلك البرامج عن بقية الأجهزة الخالية من النظام المحوسب، كما يفترق الإنسان بالروح عن بقية الحيوانات.
أبو البشر هو آدم عليه السلام. وقد خلقه الله تعالى من سلالة من طين، التي صارت بويضة ملقحة، ثم سُويت، أي أخذت شكل إنسان، ثم نفخ فيه الروح فأصبح خلقا آخر. قال الله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ؛ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ؛ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (المؤمنون، 23 / 12-14).
ولم يكن إنسان على وجه الأرض حتى خلق آدم عليه السلام. قال الله تعالى: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (الإنسان، 76 / 2).
كلمة “المذكور” في الآية التالية تعني موضوعا يذكر. وتستعمل بمعنى المعرفة. قال تعالى: « هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا». أي قد مضى عليه أمد بعيد حتى صار شيئا مذكورا؛ يدل على أن الإنسان لم يكن معروفا من قبل أن يخلق.
اقتراح للكنيسة الكاثوليكية
منذ فترة طويلة قد أصبحت الروح موضوعا دينيا بحتا، كما أن الجسد أضحى موضوعا علميا بحتا. وبما أنه لا يمكن معرفة الروح جيدا إلا مع العلم، لذا لم يقدر رجال الدين الروح حق قدرها.
لو شبهنا الدين بالروح والعلم بالجسد، كان افتراق الدين عن العلم كافتراق الروح عن الجسد، ونتيجة لهذا الحال أصبح الدين منغمسا في الأوهام والأحلام، وبالتالي بات بعيدا عن تقديم حلول مقبولة لمشاكل الحياة ومستجدات الأحداث. كما أن العلم الذي بعد عن الدين بات لا يستطيع أن يفرق بين الإنسان والحيوان، وأبرز ذلك القول بنظرية التطور، كما أصبح العلم وسيلة لكسب المال والجاه. وإذا استطعنا أن نقيم التوازن بين الدين والعلم، يمكن لهما تقديم الحلول والخدمات التي تتناسب مع الكرامة البشرية…
وهنا اقترح على الكنيسة الكاثوليكية أن نعمد _مجتمعين_ إلى تحقيق هدف ووظيفة مشتركة…
الهدف المشترك: أن نبدأ عصرا جديدا، عصر التوازن بإقامة الموازنة التامة بين الدين والعلم.
أما الوظيفة المشتركة: أن نقرأ كتاب الله المنزل المسطور في المصحف مع كتابه المخلوق المنشور في الكون. المتمثل في عالم الموجودات الكونية والتي هي مصدر كل العلوم.
لذلك فإنّ هذه الدراسة، ستوفر فرصة لرؤية الموافقة التامة بين كتاب الله المنزل المسطور في المصحف وكتابه المنشور في الكون، مما يؤدي إلى جمع الناس حول الحقائق الشمولية، كما يوفر فرصة التسابق في الخيرات. وهذه هي من أهم وظائفنا، فأداؤها على أحسن وجه يساهم في العلاقات بين الأديان والمجتمعات، كما يوفر فرصة التقدم في العلوم والتقنيات. كما أنّ دراسة الكون على هذا النهج، تخفف الأعباء المختلفة عن المجتمعات وتحمي البيئة من التلوث.
كتاب الله المنزل مسطور في المصحف، كما أنّ كتابه الذي خلقَ منشورٌ في الكون، حيث يمكن رؤيته. ويمكن الوصول بكليهما إلى القوانين الناظمة لحياة أفضل. ويمكننا أن نصل إلى القوانين باستقراء الكتاب المنشور. أمّا الكتاب المسطور فيختلف الأسلوب فيه؛ حيث لا يمكن فيه أسلوب الاستقراء بل نتبع فيه أسلوب التلقي؛ لأن الكتاب المسطور نوع من النظم القانونية التي تضمتها الآيات وهي تقدم النصائح والعظات للبشرية. ويصل المتخصصون بعلوم القرآن إلى القوانين الناظمة للحياة بمساعدة المتخصصين بالعلوم الكونية أي (الكتاب المنشور). كما أن المتخصصين بالعلوم الكونية يصلون إلى القوانين الطبيعية، بمساعدة المتخصصين بالكتاب المسطور. وبالتالي يُسدُّ الفراغ بين العلم والدين، وتتسع الآفاق المشتركة، وتتوفر الفرصة للتطور بالمحافظة على الموازنة بينهما.
[1] أنظر إلى الآيات: النمل، 27 / 23؛ مريم، 19 / 88-91؛ الدخان، 44 / 17 -29؛ هود، 11 / 44؛ الأنبياء، 21 / 69 – 71؛ الإسراء، 17 / 44؛ النور، 24 / 41؛ الزلزلة، 99 / 1-5؛ الحشر، 59 / 21؛ الأحزاب، 33 / 72.
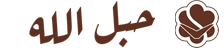


أضف تعليقا