الباحث: د. عبدالله القيسي
ما دام هناك هذا التنوع الواسع في الأديان والمذاهب، وكلٌّ منها يدّعي امتلاك الحقيقة، فما الذي يُبرّر الإيمان بأن الإسلام تحديدًا هو الدين الحق؟ ثم، أليس مجرد هذا التعدد بحد ذاته سببًا كافيًا للتشكيك في دعوى امتلاك أي دين للحقيقة، أو لنفيها عن الجميع؟
هذه أسئلة تتكرر من قِبَل منكري الأديان تجاه المتدينين بالإسلام، وسأتناول في هذا المقال هذا الإشكال عبر نقاط محددة، أُبَيِّن فيها وهْم الاستدلال بالتعدد على البطلان، وضرورة التصور الكلي لكل إنسان، تصور معرفي يفسر الوجود، وتصور أخلاقي يوجه السلوك، وما الفرق بين تقليد الفيلسوف وتقليد النبي، وما يتميز به الإسلام من بين كل التصورات المعرفية والأخلاقية.
أولًا: وهم الاستدلال بالتعدد على البطلان
القول بأن كثرة الأديان والمذاهب تستلزم بطلانها جميعًا هو استدلال مغلوط من الناحية المنطقية. ذلك أن التعدد لا يستلزم النفي الكلي، بل يستلزم وجود صادق وكاذب، حق وباطل. المثال البسيط على ذلك امتحان الطلاب: إذا اجتاز طالب واحد وفشل الآخرون، ثم ادعى كل منهم النجاح، فإن دعاوى الكثرة لا تنفي حقيقة وجود ناجح بينهم. وهكذا الشأن في الأديان؛ كثرة الدعاوى لا تنفي إمكان وجود الحق في واحد منها.
ثانيًا: ضرورة التصور الكلي للإنسان
من حيث الفلسفة، لا يمكن للإنسان أن يعيش حياة بلا تصور شامل يفسر له الوجود ويوجه سلوكه. فكل إنسان محتاج إلى:
- تصور معرفي (إبستمولوجي): يجيب عن أسئلة العقل الكبرى: من أين جاء العالم؟ ما غايته؟ ما موقع الإنسان فيه؟ وما مصيره؟
- تصور أخلاقي (إيتيقي): يضع القواعد الناظمة لحياته العملية في عالم الشهادة، ويحدد معنى الخير والشر، والعدالة والظلم، والغاية من السلوك الأخلاقي.
وإنكار الأديان والمذاهب جميعًا لا يعفي الإنسان من الحاجة إلى تصور. فحتى من يرفض الانتماء إلى أي دين علني، يجد نفسه منخرطًا في رؤية فلسفية – وُعي بها أو لم يُوعَ – تشكّل له مرجعًا في تفسير العالم. ومن ثم فهو في الحقيقة متدين بدين آخر، وإن سماه فلسفة أو منهجًا. أما من يدعي العدمية الكاملة، فإنه يسقط في تناقض منطقي وعملي؛ إذ العدمية المطلقة غير قابلة للعيش، لأن كل موقف يصدر عنه الإنسان سيكون – لا محالة – موقفًا ذا دلالة أخلاقية أو معرفية تناقض العدمية نفسها.
ثالثًا: بين الفيلسوف والنبي
المواقف الإنسانية في عمومها لا تخرج عن دائرة التقليد؛ فالناس إمّا أن يتّبعوا فيلسوفًا أو مذهبًا فكريًا، وإمّا أن ينهجوا سبيل نبيٍ مرسل. والفرق بين المسارين جوهري وعميق؛ فاتّباع الفيلسوف غالبًا ما يظلّ حبيس العقل النظري، والجدل الذهني، والنُظُم المجردة، التي قد تحرك الفكر، لكنها لا تمسّ الوجدان ولا تزكّي النفس.
أما اتّباع النبي، فهو تجربة وجودية شاملة، تتجاوز حدود الفكرة إلى حياة تُعاش، وسلوك يُمارس، وروح تُصفّى. فالدين الذي جاء به النبي يقدّم تصورًا عن الوجود، ويمنح الإنسان طريقًا للسير، ومنهجًا للتزكية، ومنظومة من الطقوس التعبدية التي تنفتح به على الغيب، وتربط قلبه بالله، وتُنمّي فيه الإرادة والخشية والحب والرجاء.
النبي يقدّم معرفة، ويقدّم قدوة، يدعو إلى الحقيقة، ويحملها، ويجسّدها، ويهدي إليها بنور الوحي. وبينما يستند الفيلسوف إلى العقل وحده، يستند النبي إلى الوحي والعقل معًا، ويُخرِج الإنسان من ضيق ذاته إلى سعة الأفق الإلهي، ويمنحه غاية نهائية ومصيرًا واضحًا.
ولذلك، فالتقليد للنبي دخول في علاقة روحية عميقة، تملأ القلب، وتُعيد تشكيل الكيان الإنساني كله، عقلًا وروحًا وسلوكًا.
رابعًا: جدلية الجسد والروح
الإنسان كائن ذو طبيعتين متداخلتين: جسدية وروحية. وأي تصور يقتصر على جانب واحد منهما يوقع الإنسان في الاغتراب والذبول. فالمنغمس في متعة الجسد يملّها مع الزمن، والمنغمس في متعة الروح وحدها يفقد التوازن. أما التصور الإسلامي فيوفّر للإنسان حركة جدلية متوازنة بين اللذتين: كلما بلغ ذروة المتعة الجسدية، استيقظ فيه الشوق إلى المتعة الروحية، والعكس بالعكس، فتستمر الحياة في تناغم دائم. هذه الجدلية تجعل الإسلام أقرب إلى طبيعة الإنسان وفطرته، بل تجعل الدين ضرورة فطرية قبل أن يكون مجرد خيار ثقافي.
الإنسان ليس كيانًا ماديًا صرفًا ولا روحًا خالصة، بل هو مزيج من الجسد والروح، تتداخل حاجاته وتتشابك رغباته، ولا تستقر حياته ولا يزدهر وجوده إلا إذا أُخذ بكليّته. ولهذا، فإن أيّ تصور فلسفي أو عقدي يُغفل أحد هذين الجانبين أو يُعطي أحدهما غلبة مطلقة على الآخر، يُنتج إنسانًا ناقصًا، مضطرب التوازن، مشوش الهوية، يشعر في أعماقه بالغربة عن نفسه والكون من حوله.
والفكر المادي حين يُغرق الإنسان في ملذات الجسد، ويحصر المعنى في الحسّ والمادة، يُوصله مع الزمن إلى الفراغ، والملل، والانفصال عن ذاته. بينما الفلسفات الروحية الخالصة أو التصوف المنفصل عن الواقع، وإن بدا في ظاهره ساميًا، إلا أنه يُعرّض الإنسان للهروب من واقعه، ويُهمّش حاجاته الفطرية، ويقوده أحيانًا إلى التجريد العقيم أو الزهد القاسي الذي يُجفف الحياة من معناها الحسي الجميل.
أما التصور الإسلامي، فتميزه يكمن في بنائه المتوازن الذي يدرك أن الإنسان لا يحيا بالروح وحدها ولا بالجسد فقط، بل بهما معًا. يمنح الإسلام الجسد حقه دون غلو، ويعترف بالمتعة الحسية في حدود ما أباح الله، ويجعل من لذائذ الحياة سبيلًا للشكر والتزكية لا مدعاة للغفلة والعبث. وفي الوقت ذاته، يوقظ في النفس شوقها الدائم للارتقاء، ويغذي الروح بالعبادة والمعرفة والتأمل.
إن الإسلام، في نظرته الكلية للإنسان، يخاطب فطرته، ويهذب غرائزه، ويُنير عقله، فيمنحه بذلك توازنًا فريدًا لا يتحقق في غيره من التصورات الوضعية. ومن هنا، يكون الدين ضرورة فطرية ووجودية تلبي أعمق ما في الإنسان من حاجات وتطلعات.
خامسًا: الإسلام كتصور معرفي (إبستمولوجي)
الإسلام كتصور معرفي (إبستمولوجي) يتميّز بخصوصيته وتوازنه الفريد بين العقل والوحي، وبين الشهادة والغيب، مما يجعله من أكثر التصورات الفلسفية والدينية شمولاً وعمقًا في تفسير الوجود، وفيما يلي ملامح تميّزه المعرفي:
- التوحيد الخالص
الإسلام ينطلق من تصور توحيدي محض، يرفع الله فوق الزمان والمكان، ويُنزّهه عن التشبيه والتمثيل، فلا يُقاس بالخَلْق، ومع ذلك يُثبِت له صفات الكمال دون تعطيل. فالله في الإسلام “ليس كمثله شيء” تنزيهًا، وهو “السميع البصير” إثباتًا. هذه المعادلة الدقيقة بين التنزيه والإثبات لا توجد بهذا التوازن في غيره من الأديان.
- شمول المعرفة بالغيب والشهادة
الرؤية الإسلامية لا تقتصر على العالم المحسوس (عالم الشهادة)، بل تتسع لتشمل الغيب: كوجود الروح، والملائكة، والوحي، والآخرة، وغير ذلك. وهذا التمدد المعرفي يحرّر العقل من اختزال الوجود في المادي، ويوسّع أفق الإنسان ليرى ما وراء الظواهر، دون أن يُلغى دور العقل أو يقع في الخرافة. فالعقل في الإسلام خادم للوحي، ومُكمِّل له، لا خصمٌ ولا بديل.
- الرؤية الأخروية كمحور تأويلي للوجود
الآخرة في الإسلام هي مركز التأويل، ومعيار القيمة، وأفق الحرية. فمعاناة الإنسان، وجهده، وتضحياته لا تذهب سدى، بل تُرد إلى عدالة إلهية مطلقة تحسم كل المظالم وتمنح كل خير جزاءه. وهذه الرؤية تُضفي على الحياة معنى لا يتوفر في التصورات المادية أو الفلسفية المجردة، حيث يُترك الإنسان للعبث أو للصدفة.
- تكامل مصادر المعرفة
يُقر الإسلام بالعقل والحسّ كوسيلتين مشروعتين للمعرفة، لكنه لا يقف عندهما، بل يُضيف “الوحي” كمصدر أعلى وأشمل، يوجه العقل ويُصحّح مساره ويُنبّهه إلى ما لا يبلغه وحده. فالمعرفة الإسلامية ليست مادية فقط، ولا حدسية فقط، بل هي نسيج من الوحي والعقل، والتجربة والتأمل، مما يجعلها أكثر اتساقًا مع فطرة الإنسان وتطلعاته.
- مركزية الإنسان وخلافته في الأرض
في التصور الإسلامي، الإنسان خليفة في الأرض، حامل لأمانة، ومكرَّم بالعقل والحرية. وهذه النظرة تجعل المعرفة مرتبطة بالمسؤولية الأخلاقية، وتُخرِجها من الحياد البارد إلى ساحة التكليف والمغزى. فالمعرفة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للهداية والعمل الصالح.
بهذا البناء المعرفي المتكامل، يقدّم الإسلام رؤية متوازنة تُعلي من شأن العقل دون أن تَعبده، وتفتح أفق الغيب دون أن تهرب من الواقع، وتُؤسس للمعرفة على التقديس دون أن تُفقدها مصداقيتها.
سادسًا: الإسلام كتصور أخلاقي
الإسلام كتصور أخلاقي يقدّم رؤية متكاملة ومتفردة للإنسان بوصفه كائنًا حرًا مسؤولًا، يتفاعل مع غيره ضمن شبكة من القيم التي تستمد مرجعيتها من الوحي الإلهي، وتتناغم مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد. وعلى عكس النماذج الأخلاقية الوضعية التي تنشأ غالبًا من تصورات نسبية أو مصالح بشرية متقلبة، ينطلق الإسلام من بنية أخلاقية ثابتة وعادلة، ترتكز على ثلاث قيم كبرى مترابطة:
- الحرية المسؤولة:
في التصور الإسلامي، الإنسان مخلوق مكرّم حرّ، يمتلك إرادة وقدرة على الاختيار، لكنه ليس حرًا بشكل عبثي، بل حرية مشروطة بالمسؤولية أمام الله، وأمام الناس، وأمام ضميره. فحرية الإنسان في الإسلام ليست خاضعة لإملاءات السوق أو تقلبات الأهواء، كما أنها لا تُختزل في استقلال فردي منفصل عن القيم. إنها حرية تُشجّع الإبداع والتفكير والمبادرة، لكنها في الوقت ذاته تحمله وعيًا بالجزاء والمساءلة، في الدنيا والآخرة، ما يمنحها توازنًا فريدًا بين الانطلاق والانضباط.
- العدالة الشاملة:
العدالة في التصور الإسلامي قيمة جوهرية متأصلة في طبيعة الشريعة وفي علاقة الإنسان بخالقه وبالمجتمع. إنها عدالة لا تعرف المحاباة، ولا تحابي صاحب سلطة أو مال، بل تضمن لكل إنسان حقه، وتفرض عليه واجباته، بغضّ النظر عن لونه أو جنسه أو طبقته. وهي تتجاوز المفهوم القانوني المجرد إلى عدالة وجدانية تُنصف حتى في المشاعر والمعاملات اليومية. وبهذا المعنى، فالعدالة ليست فقط واجبًا اجتماعيًا، بل عبادة وقربى.
- الرحمة كروح أخلاقية:
الرحمة في الإسلام قيمة تأسيسية تُشكّل روح النظام الأخلاقي كله. فالرحمة تحكم علاقة الإنسان بربه، وتحكم علاقته بأخيه الإنسان: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وحتى بالحيوان والبيئة. وهي لا تُناقض العدالة، بل تكمّلها وتلطّفها. فالعدالة تمنع الظلم، لكن الرحمة تمنع القسوة. وهي تمنح التشريعات الإسلامية بُعدًا إنسانيًا رفيعًا، يجعل القانون الإسلامي أداة إصلاح وتزكية لا آلة عقاب.
بهذا التكامل بين الحرية والعدالة والرحمة، يحقق التصور الإسلامي توازنًا أخلاقيًا لا مثيل له؛ حرية تنأى عن الفوضى، وعدالة لا تنفصل عن الرحمة، ورحمة لا تتحول إلى ضعف أو تساهل على حساب القيم. وهو توازن لا نكاد نجده في أي منظومة أخلاقية بشرية، لأن مصدره الوحي الإلهي، الذي يعلم طبيعة النفس البشرية ويخاطبها بكل مستوياتها: العقلية، والوجدانية، والروحية.
سابعًا: الإسلام في أفق المقارنة الدينية والفلسفية
– الأديان التي جسّدت الإله في صورة مخلوقة أو طبيعية انتقصت من جلاله وكماله، وجعلت الإله شبيهًا بالمحدود الزائل.
– الفلسفات التي أنكرت الغيب والروح والآخرة وقعت في قصور معرفي، إذ اكتفت ببعد واحد من الوجود، وفشلت في تفسير ظواهر الوعي والضمير والمعنى.
– وحده الإسلام قدّم تصورًا لله جامعًا بين التنزيه والكمال، وصاغ نظرية معرفية تتسق مع العقل والوجدان، ومنظومة أخلاقية تجمع بين الحرية والعدالة والرحمة.
ومن هنا، فإن القول بأحقية الإسلام ينبع من قراءة فلسفية موضوعية تبيّن أن الإسلام هو التصور الأكثر انسجامًا مع متطلبات العقل، والأكثر تكاملًا مع فطرة الإنسان، والأقدر على منح الحياة معنى وغاية، والأعمق أثرًا في تحقيق انسجام الإنسان مع ذاته، ومع العالم، ومع خالقه.
*المصدر: كتاب “عودة القرآن” للدكتور عبدالله القيسي
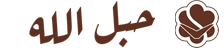


هذا الكتاب، يقدم تصورًا فريدًا للإنسان، يخاطب جسده وحياته الحسية كأحداث في مسلسل كوميدي رومانسي، ولكنه يضيف مع ذلك حوارًا روحيًا لم يسبق له مثيل! يفتخر بالوحي كنجم درع، ويعترف بالعقل كضيف رائع. لكن هل الإنسان بحاجة لكل هذا الدعاية لكى يتعلم أن يتنازل عن لحمه ودمه في مواقف معينة؟ أحيانًا، يكفي فكرة بسيطة بأن الجسد والروح مجردتين يهتزمان في فنادق الذاكرة! والأخير، من يضمن أن النبي كان مجرد فيلسوف محدود مدعومًا بالوحي؟ شكرًا جزيلاً لتقديم هذه النظرة المتوازنة.