23. الإلهام
الإلهامُ هو أن يُوقِعَ اللهُ في قلب العبد شيئاً،[1] ويُستعمَلُ الحدسُ بمعنى الإلهام أيضاً.
المُريد : هل تؤمنُ بالإلهام؟ فالإلهامُ موجودٌ غير أنَّه لا يهمُّ الآخرين.
بايندر: لا شكَّ في وجود الإلهام، ولو لم يكن الإلهامُ موجوداً لَمَا استطاعَ الإنسانُ المضيَّ في حياته، وكلُّ ما تعلَّمه واكتشفه فبإلهامِ الله إيَّاه، لكنَّ الإلهامَ يستوي فيه المُسلمون والكافرون، وليسَ خاصَّاً بالمسلمين دون غيرهم. وهذه اللَّفظةُ لا تمرُّ في القُرآن إلَّا في موضع واحدٍ، قالَ تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (الشَّمس، 1/8-10). فالنَّفسُ تُلهَمُ التَّقوى كما تُلهَمُ الفجور.
أ – إلهام الفجور
والفجور في مُفردات الرَّاغب الأصفهاني شقُّ ستر الدِّيانة، وهو العصيان، أي أن يُعامِلَ المرءُ اللهَ تعالى أو يُعاملَ نفسَه أو النَّاسَ مُعاملةً سيِّئة. هذا، وهو قبل وبعد المعصية في حزن، يُقالُ له القلق الدَّاخليُّ أو العذابُ النَّفسيُّ.
والبرهان الذي صَرَفَ يوسُفَ عليه الصَّلاة والسَّلام عن “زليخا” لا بدَّ أن يكونَ من الله تعالى الذي يُلهمُ النَّفسَ فجورَها وتقواها، قال تعالى: « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ » (يوسف، 12/24).
والإنسانُ إذا أراد أن يقومَ بمعصيةٍ يُلهمُه اللهُ فجورَه وتقواه فيقشعرُّ جلدُه، ثمَّ إمَّا أن يُعرِضَ عنها وإمَّا أن يقعَ فيها، واللهُ تعالى من رحمته الواسعة يُحذِّرُ عبدَه من المعصية قبلَ وقوعه فيها، وبعد إصابته المعصية يشعرُ بضيقٍ داخليٍّ يحثُّه على التَّوبة.
وأمَّا إن كان من المُدمنين على المعصية فلا يُؤثِّرُ فيه الإلهامُ قبل وقوعه فيها، بل يجدُ فيها لذَّةً، وهذا مِصداقُ قوله تعالى: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (البقرة، 2/7)، وقوله تعالى: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» (فاطر، 35 / 8). وفاعل يشاء في كلتا الجملتين هو (مَنْ) وليس اللهَ تعالى، تعالى عن الظُّلم، وأمَّا بعد وقوعه في المعصية فإنَّه يجدُ ضيقاً في نفسه، وهذا الشُّعورُ هو رحمةٌ من الله إليه يحملُه على التَّوبة.
والآياتُ التي سنقرؤُها تُبيِّنُ أنَّ هذا الاضطرابَ يحدثُ حتَّى لغير المسلمين، ولننظرْ قبل ذلك في سبب نزولها: و النفر الذين آذوا رسولَ الله، وهم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا: إنَّ وفودَ العرب يجتمعون في أيَّام الحجِّ ويسألوننا عن أمر محمد، فكلُّ واحدٍ منَّا يُجيبُ بجوابٍ آخر، فواحدٌ يقول: مجنون، وآخر يقول: كاهن، وآخر يقول: شاعر، فالعرب يستدلُّون باختلاف الأجوبة على كون هذه الأجوبة باطلةً، فتعالوا نجتمعُ على تسمية محمد باسمٍ واحدٍ، فقال واحد: إنَّه شاعرٌ، فقالَ الوليدُ: سمعتُ عبيد بن الأبرص، وكلام أمية بن أبي الصلت، وكلامُه ما يُشبهُ كلامَهما، وقال آخرون: كاهن، قال الوليد: ومن الكاهن؟ قالوا: الذي يُصدِّقُ تارةً ويُكذِّبُ أُخرى، قال الوليد: ما كَذَبَ محمد قط، فقال آخر: إنَّه مجنونٌ، فقال الوليد: ومَنْ يكونُ المجنون؟ قالوا: مُخيفُ النَّاس، فقال الوليد: ما أخيف بمحمَّد أحد قط، ثم قامَ الوليدُ وانصرفَ إلى بيته، فقال النَّاس: صبأ الوليد بن المغيرة، فدَخَلَ عليه أبو جهل، وقال مالك يا أبا عبد شمس؟ هذه قُريشُ تجمعُ لكَ شيئاً، زعموا أنَّكَ احتججتَ وصبأتَ، فقال الوليدُ: مالي إليه حاجةٌ، ولكنِّي فكَّرتُ في محمد فقلتُ: إنَّه ساحرٌ، لأنَّ السَّاحرَ هو الذي يُفرِّقُ بين الأب وابنه وبين الأخوين، وبين المرء وزوجه ثم إنَّهم أجمعوا على أن يُلقِّبوا به محمد عليه الصَّلاة والسَّلام، ثمَّ خرجوا فصرخوا بمكَّة واجتمع النَّاسُ حولهم، فقالوا: إنَّ محمداً لساحرٍ، فوقعت الضَّجَّةُ في النَّاس أنَّ محمداً ساحرٌ، فلمَّا سَمِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك اشتدَّ عليه، ورَجِعَ إلى بيته محزوناً فتدثَّرَ بثوبه، فأنزلَ اللهُ تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِر».[2]
فالوليدُ بن المُغيرة كان يشعرُ بضيقٍ وشدَّةٍ تظهرُ عليه حين يتَّخذُ القرارَ، لأنَّه كان مُتلبِّساً بمعصيةٍ كبيرةٍ، وهذه الآياتُ تُبيِّنُ هذا: « إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ» (المدثر، 74/18-25).
كلُّ مَنْ خالفَ المُسلمين شَعَرَ بالحرج وقلَّة الرَّاحة، لهذا يبدو عليه الاضطراب في تصرُّفاته: « رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ» (الحجر، 15/2). والكفَّار في رِيبة: «لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة، 9/110).
وهذه الرِّيبةُ رحمةٌ من الله لهم حتَّى أنَّه قد رَجَعَ بعضَهم إلى صوابه وأعرَضَ عن سوء أفعاله، والذي يقعُ في المعصية يلهَم الضِّيق والنَّدم مِنَ الله تعالى ليقبل على التَّوبة، وهذا من رحمة الله الكبرى بعباده.
ب – إلهام التَّقوى
التَّقوى أنَّ تُجنِّبَ نفسَكَ الوقوع في المُنكَر، ويجبُ على الإنسان تجنُّبُ المُنكَر في معاملاته مع الله تعالى ومع النَّاس ومع نفسه، وبهذا يبتعدُ عن المساوئ في الدُّنيا والعذاب في الآخرة، وهو يتحقَّقُ بالقيام بالطَّاعات واجتناب المعاصي.
ويرتاحُ الإنسانُ بالأعمال المُؤدِّيةِ إلى التَّقوى ويشعرُ بالسَّعادة والاستقرار، وهذه السَّعادةُ وهذا الاستقرارُ كلاهما إلهامٌ من الله تعالى. كما نفهمُ ذلك من الحديث التَّالي:
عن وابصة بن معبد الأسدي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئتَ تسألُ عن البِرِّ والإثم؟ قال: نعم. قال: فجمَعَ أصابعَه فضربَ بها صدرَه. وقال: استفتِ نفسَك، استفتِ قلبَك يا وابصة – ثلاثاً- البرُّ ما اطمأنَّتْ إليه النَّفسُ واطمأنَّ إليه القلبُ، والإثمُ ما حاَكَ في النَّفسِ وتردَّدَ في الصَّدر، وإن أفتاك النَّاسُ أوأفتوك[3].
وفي حديثٍ آخر قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام: “دعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبُك، فإنَّ الصِّدقَ طمأنينةٌ، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ”.[4]
وليسَ كلُّ ما يتولَّدُ في النَّفسِ إلهاماً، فالشَّيطانُ له وسوستُه: «الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» (الناس، 114/5-6).
وذكَرَ اللهُ تعالى قولَ الشَّيطان بعد أن أمهلَه: «قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ» (الأعراف، 7/16-18).
فالشَّيطانُ يُريدُ أن يُغويَ كلَّ النَّاس ويُبعدَهم عن الصِّراطِ المُستقيمِ بما فيهم الأنبياء، قالَ تعالى: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الحج، 22/52).
وإذا أردْنا أن نُميِّزَ بين الإلهام وبين الوسواس وجَبَ علينا أن نعرضَ ما نجدُه في أنفسِنا على أوامر الله ونواهيه، فالنَّفسُ المُلهَمة هي هذه النَّفس، وكلٌّ مِن نفس المؤمن والكافر نفسٌ ملهَمة، فاللهُ تعالى يُلهمُها فجورَها، ويلهمُها تقواها.
المُريد : ألا يوجدُ إلهامٌ آخرُ غيرُ إلهام التَّقوى وإلهام الفجور؟
بايندر : بلى، فاللهُ تعالى يُلهمُ الإنسانَ الكثيرَ في قلبه، وقد مرَّتْ آياتٌ عن هذا في فصل الوحي، فهذا يقعُ لكلِّ النَّاس مؤمنهم وكافرهم، والشُّعراء والمخترعون مثالٌ على هذا.
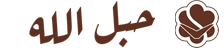


أضف تعليقا